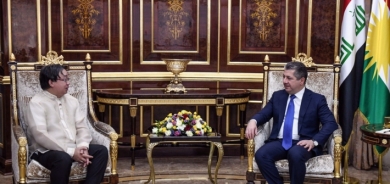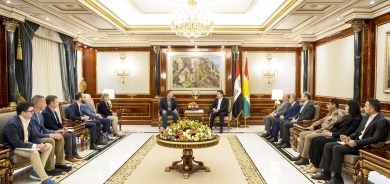«حماس» وإسرائيل: ماذا بعد؟

أمير طاهري
«لم يكن الشرق الأوسط أكثر هدوءاً مما هو عليه اليوم على امتداد العقديْن الماضييْن»، هكذا تفاخر جيك سوليفان، مستشار الأمن الوطني للرئيس الأميركي جو بايدن، بالنجاحات المزعومة التي حقّقتها الإدارة الأميركية في «تعزيز قضية السلام» في منطقة لم تنعم بالسلام لأكثر من 100 عام.
جاءت تصريحات سوليفان المفرطة في تفاؤلها الساذج قبل أيام قلائل من شن «حماس» هجومها الأكثر دموية على إسرائيل حتى الآن؛ ما أثار نوعاً من الأزمات، حتى المتشائمون في رؤيتهم تجاه الشرق الأوسط، مثل كاتب هذا المقال، كانوا يظنون أنها باتت في حكم الماضي.
وعلى الفور، تمخض عن الهجوم ظهور تحليليْن:
يدور الأول حول أن إسرائيل عايشت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) نسختها من هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) التي ضربت الولايات المتحدة. ومع ذلك، يبقى الهجوم الذي واجهته إسرائيل في السابع من أكتوبر أسوأ من هجمات الحادي عشر من سبتمبر. جدير بالذكر أن الهجوم الذي نفّذه تنظيم «القاعدة» ضد الولايات المتحدة، أسفر عن مقتل ثلاثة آلاف شخص، في حين تنعى إسرائيل أكثر من ألف شخص من جرّاء الهجوم الأخير. ومع تعديل الأرقام لتعكس الفارق بين البلدين من حيث عدد السكان نجد أن إسرائيل فقدت ما يعادل ثلاثين ألف مواطن أميركي.
أما التحليل الثاني فيشير إلى إخفاق الاستخبارات الإسرائيلية، التي من المفترض أنها الأفضل على مستوى العالم، في معرفة ما يوشك على الحدوث، تماماً مثلما أخفقت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
إلا أن ما ينبغي الانتباه إليه أن السابع من أكتوبر أنهى الوضع الذي ظلّ قائماً بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة منذ عام 2009، عندما كانت إسرائيل هي التي خرقت الوضع القائم السابق.
بوجه عام، يجري كسر الوضع القائم بين طرفيْن متحاربيْن، عندما يشعر أحدهما بأنه من المتعذر تحمّله.
عام 2009 لم تعد إسرائيل قادرة على تحمّل القصف اليومي الذي يستهدف بلداتها وقراها في الجنوب. في ذلك الوقت، تحدّث قادة الجيش الإسرائيلي عن «جز العشب» في غزة أو قطع أعشاب «حماس» السامة.
وبلغت هذه الحملة ذروتها عامي 2008-2009 مع انطلاق عملية «الرصاص المصبوب» التي حوّلت جزءاً كبيراً من القطاع إلى ركام، في حين تركت الأعشاب السامة على حالها تقريباً.
في ذلك الوقت، أعلن قادة إسرائيل رغبتهم في «كسر عظام حماس»، لكن ليس لدرجة إصابتها بالعجز الكامل.
وهم بذلك تجاهلوا نصيحة أحد الكتاب من فلورنسا بأنه «لا تجرح عدواً فتاكاً، ثم تتركه ليتعافى! إما أن تحوّله إلى صديق وإما أن تقتله».
من جهتهم، حاول قادة إسرائيل تطبيق استراتيجية استخدموها ضد الدول العربية المجاورة المعادية منذ عام 1948: «حملهم إلى طبيب الأسنان كل عشر سنوات لتقليم أنيابهم».
أما الخطأ الذي اقترفه الإسرائيليون فهو عدم التمييز بين هياكل الدول التقليدية التي تتولى إدارة البلاد، والاستجابة إلى الحد الأدنى من احتياجات مجتمعها، وجهة غير حكومية لا تبدي اهتماماً يُذكر بالشعب الذي يعيش تحت حكمها. وبالفعل، كانت «حماس» في موقف يمكنها من التجاهل التام لاحتياجات الناس الذين يعيشون في القطاع. من جهتها، تتولى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) تغطية الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، وذلك بمعاونة أكثر من مائة منظمة غير حكومية من ثلاثين دولة، إلى جانب تبرعات متكررة من دول راغبة في التضامن مع الفلسطينيين. وفي بعض الحالات، يصل الأمر إلى تحمّل جهات أجنبية مانحة أجور الموظفين في الإدارة المحلية.
وبفضل «هدايا» من «قوى صديقة بعينها»، لا تحتاج «حماس» وشريكها الأصغر «الجهاد الإسلامي لتحرير فلسطين» إلى شراء الأسلحة التي تعتمد عليها.
ربما يكون الهجوم الذي شنته «حماس» قد نبع من انتهازية محضة، بمعنى أن قادتها لم يستطيعوا تجاهل الأزمة السياسية غير المسبوقة التي أحدثتها محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكبيل المحكمة العليا الإسرائيلية. كما أنهم لاحظوا حتماً حملة الرئيس بايدن غير المباشرة لدفع نتنياهو خارج السلطة. كما أن انتقادات بعض المانحين الأجانب بأن «حماس» تتلقى مبالغ ضخمة من المال، من دون أن تبذل الكثير للنهوض بـ«القضية»، ربما أسهمت في قرار الجماعة بكسر الوضع القائم.
السؤال الآن: ماذا بعد؟ يمكن أن يكون كسر الوضع القائم وسيلة فاعلة لإنهاء جمود موقف ما، بشرط أن تطالب الجهة التي تكسر الوضع القائم بشيء لدى الخصم القدرة على تقديمه. على سبيل المثال، بعد كسر الوضع القائم من خلال شن حرب أكتوبر، استعادت مصر أراضيها المفقودة. وفي سياق مماثل، ضمن الأردن أمان حدوده المتفق عليها عن طريق التطبيع مع إسرائيل.
ومع ذلك، فإنه في حالة «حماس» لا يمكن تصور أي من هذه النتائج، فـ«حماس» لا ترغب في الحصول على أراضٍ، لأن إسرائيل قد انسحبت بالفعل من قطاع غزة عام 2005. ولو كانت «حماس» تعمل بالفعل على بناء دولة كان يمكنها استغلال العقديْن الأخيريْن لجذب استثمارات أجنبية، بما في ذلك من الفلسطينيين الأثرياء في جميع أنحاء العالم، بهدف تحويل القطاع إلى قوة صغيرة نابضة بالحياة على ضفاف البحر المتوسط. وربما كانت إسرائيل وأصدقاؤها ليساعدوا في محاولة تقليص المشاعر الانتقامية في نفوس الفلسطينيين.
إلا أن «حماس»، مثلما ينص ميثاقها بوضوح، لا تهتم ببناء دولة، وإنما تسعى إلى القضاء على إسرائيل - أمر من غير المحتمل أن يقدمه إليها الإسرائيليون.
وعليه، ربما ينتهي الحال بـ«حماس» إلى وضع قائم أسوأ من السابق، مع استمرار التدمير في القطاع، ونفاد أسلحتها، وإرسال أفضل مقاتليها إلى أتون القتال. أما التهديد بإعدام الأسرى، وبينهم مواطنون من بلدان أخرى غير إسرائيل، فإنه قد يقضي على جزء كبير من التعاطف تجاه «القضية» الفلسطينية، وبخاصة في الغرب.
والأسوأ لـ«حماس»، أن إسرائيل قد تستعيد صورة الضحية التي كانت قد فقدتها لأسباب، منها جهود شخصيات وتيارات معادية للسامية بشتى أرجاء العالم. في المقابل، تعيد العمليات الأخيرة لـ«حماس» الصورة القديمة إلى الفلسطينيين بوصفهم إرهابيين وخاطفي رهائن - صورة نجح محمود عباس وجماعته في تغييرها عبر عقود من المثابرة، بل الذل.
وفي خضم تشكيل وضع جديد، يبقى زمام المبادرة، لدرجة كبيرة، بيد نتنياهو. وانطلاقاً من شعوره بأن مسيرته المتقلبة بمنصب رئيس الوزراء ستنتهي حتماً، فإن خيار شمشون المرتبط بالتدمير الشامل ربما يغريه. وإذا اختار ذلك فسيكون بذلك قد تصرّف خلافاً لشخصيته، بالنظر إلى أنه تحلّى بالحذر حتى الآن إزاء استخدام الخيار العسكري.
إلى جانب ما سبق، تكشف المواجهة الحالية عن عجز أو عدم رغبة إدارة بايدن في التخلص من السياسة الكارثية تجاه الشرق الأوسط التي اتبعها الرئيس باراك أوباما من قبل بتجاهل الأصدقاء، على أمل إضفاء دفء على العلاقات مع الأعداء.
هناك قولٌ لجيك سوليفان نصه: في الشرق الأوسط، عندما تبدو الأمور على ما يرام، ينبغي لك حينها أن تترقب أخباراً سيئة.
الشرق الأوسط