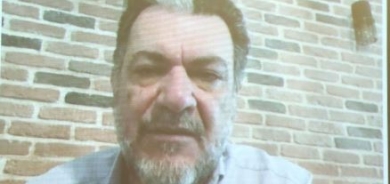هل من سبيل لإنعاش مفهوم الالتزام؟

نشأت مجلة الآداب إذاً لكي «تكون ميداناً لفئة أهل القلم الواعين الذين يعيشون تجربة عصرهم، ويُعدّون شاهداً على هذا العصر.» فالمثقفون، في نظرها، وبما أنهم يعكسون حاجات المجتمع، ويعبّرون عن شواغله، فهم الموكول إليهم أن يشقُّوا الطريق أمام المصلحين.
ليس الأدب الذي تنشده المجلة وتتوخى ذيوعه هو «الأدب للأدب»، فهي لا تقول بنظرية «الفن للفن»، وإنما هو أدب يرتبط أوثق ارتباط بالمجتمع. إنه، على حدّ تعبير الإفتتاحية: «أدب "الالتزام" »الذي ينبع من المجتمع ويصبّ فيه.
كثير من الأفكار التي وردت في هذه الإفتتاحية يمكن أن نعثر على مثيلاته في افتتاحية مجلة أخرى كانت قد ظهرت فيما سبق في باريس، أقل من عقد من السنين، هي مجلة «الأزمنة الحديثة»، وفيها، كما نعلم، يدعو سارتر إلى «أدب الإلتزام» هذا. ولا شك أن الدكتور سهيل إدريس كان يحرّر الإفتتاحية وانتباهه منشدّ إلى ما جاء في العدد الأوّل من هذه المجلة التي رآها «في الحيّ اللاتيني»، والتي لا شك أنه اطلع على أعدادها في مهدها وربما في إحدى مقاهي «الحي اللاتيني» على غرار ماكان يفعل معظم مؤسسيها.
نعلم أن الإلتزام لم يكن عند صاحبه نداء، ولا حتى نظرية، وإنما كان ممارسة، وككل ممارسة فهي تُشرط بظروف البيئة المترعرعة فيها. والظاهر أن البيئة التي سعت مجلة الآداب أن تنقل إليها هذا المفهوم- الممارسة لم تكن مهيأة لأن يفعل فيها، أو على الأقل لم تكن مهيأة لأن يفعل فيها الفعل نفسه.
ذلك أن ما كان يميّز السياق الذي ظهرت فيه «الأزمنة الحديثة» هو حضور المثقف، ليس كفرد يحمل هموم المجتمع، وإنما كقوة اجتماعية يحسب لها السياسي ألف حساب. وكلنا يذكر رد فعل الجنرال دوغول عندما أُلقِي القبض على سارتر في إحدى المظاهرات، فقد صاح محتجا: « لا يمكن أن نلقي القبض على فولتير».
فرق كبير إذاً بين سياق ظهور المفهوم في بيئته الأولى، وظرفية ظهوره في الوسط المنقول إليه. وما بالك إن أخذنا بعين الإعتبار، إلى جانب هذا الفرق، البعد القومي الذي أراده مؤسس مجلة «الآداب» لهذا المفهوم، بل ولكل عمل ثقافي. فحيث يتحدث مؤسس «الأزمنة الحديثة» عن الأدب والمجتمع، يربط صاحب افتتاحية «مجلة الآداب » العمل الثقافي ببعد يتجاوز المجتمع نحو مفهوم «الأمة» و«القومية». نقرأ في هذه الإفتتاحية: « والمجلة، إذ تدعو إلى هذا الأدب الفعّال، تحمل رسالة قوميّةً مُثلى. فتلك الفئة الواعية من الأدباء الذين يستوحون أدبهم من مجتمعهم يستطيعون على الأيام أن يخلقوا جيلاً واعياً من القراء يتحسسون بدورهم واقع مجتمعهم، ويكوّنون نواة الوطنيين الصالحين. وهكذا تشارك المجلة، بواسطة كتّابها وقرائها، في العمل القومي العظيم، الذي هو الواجب الأكبر على كلّ وطنيّ».
صحيح أن مؤسس مجلة الآداب لا يرى تعارضا بين هذا النزوع القومي وبين العالمية، بل إنه يعتبره الطريق المؤدي إليها، فهو يكتب: « على أنّ مفهوم هذا الأدب القوميّ سيكون من السعة والشمول حتى ليتّصل اتصالاً مباشراً بالأدب الإنساني العام، ما دام يعمل على ردّ الاعتبار الإنساني لكل وطني، وعلى الدعوة إلى توفير العدالة الاجتماعية له، وتحريره من العبوديات الماديّة والفكرية، وهذه غاية الإنسانية البعيدة. وهكذا تُسهِم المجلة في خلق الأدب الإنساني الذي يتسع ويتناول القضية الحضارية كاملة، وهذا الأدب الإنساني هو المرحلة الأخيرة التي تنشدها الآداب العالمية في تطوّرها»، إلا أن الاختلاف يظل جوهريا بين تصورين لمفهوم الإنسان-الفرد، ووظيفة الكاتب، ودور المثقف، ومفهوم الإلتزام. فافتتاحية الدكتور سهيل لا تحيل أساسا إلى الكاتب بما هو عنصر في مجتمع تفعل فيه حركات اجتماعية وقوى حية، وإنما بما هو عضو مدرك لبعده القومي وانتمائه إلى أمة لها قيمها وثوابتها. كما أن تلك الإفتتاحية لا تسند أقوالها على نماذج فكرية من ورائها، وهي لا تحيل إلى فولتيرأو ديدرو أو غيرهما. لعل ذلك اعتقادا من صاحبها أن انزياح المفهوم عن سياقه لا يؤثر عليه كبير تأثير. إلا أننا لايمكن أن ننكر ما ترتب عن ذلك، فانعكس على الممارسة الفعلية وعلى تطبيق المفهوم في البيئة المنقول إليها، وبالتالي على الصعوبات التي واجهته في أن يجد إجرائيته في هذا الوسط «الجديد» الذي نقل إليه.
لعل ذلك هو ما يفسر الصمت الذي لاحظنا أنه شاب المفهوم فيما بعد، مقابل الحيوية التي عرفها في الوسط الذي ترعرع فيه حيث ظل محط تنقيح وإعادة نظر من جيل إلى جيل، بل إنه قد عرف نوعا من القلب الجذري وتغيير المحتوى عند بعض من خلفوا سارتر، ولعل أهمهم رولان بارط.
ولا بأس أن نتوقف قليلا عند هذا التغيير الأساس بهدف تلمُّس الحيويّة التي ظل المفهوم يعرفها في بيئته التي ولد وترعرع في حضنها. نعلم أن رولان بارط لن يذهب حتى رفض المفهوم، إلا أنه سيغير مضمونه تغييرا جذريا. لا ينبغي أن ننسى بأن سارتر وبارط ينتميان ثقافيا لجيلين متعارضين: الأول للجيل الوجودي الذي كان يعتقد أن الإنسان هو الذي يخلق المعنى، بينما الثاني للجيل البنيوي الذي يعتقد أن المعنى يحصل ويجيء إلى الإنسان ويقتحمه.
فرغم أننا نجد عند ر.بارط، كما هو الشأن بالنسبة لسارتر، الرغبة نفسها في التوفيق بين التاريخ والحرية، والنفور ذاته من الإيمان الفاسد وسوء الطوية الذي ينطوي عليه الأدب البرجوازي الذي يستكين إلى«الخمول الثقافي»، ورغم أن بارط يعتقد أن بإمكان السيميولوجيا الأدبية أن تعمل على إنعاش النقد الاجتماعي «فتلتقي مع المشروع السارتري»، ورغم أن بارط يبدي إعجابه بمفهوم الالتزام، إلا أنه لم يكن قط ليطيق لغة النضال، وإلى حدّ ما لغة المباشرة، التي لم يستطع سارتر أن يحيد عنها. ويكفي دلالة على ذلك أن نتذكر ما قاله هذا الأخير عن فلوبير مثلا حينما اعتبره «مسؤولا عن القمع الذي أعقب الكمونة لأنه لم يكتب ولو سطرا واحدا للحيلولة دونه».
لقد كان بارط يعتقد أن الأدب لا يمكنه أن يعالج إلا اللغة، وبالتالي فإن الالتزام لا يظهر فيه إلا عبر الكتابة. ذلك أنه يميّز بين :اللغة التي هي منظومة من القواعد والعادات التي يشترك فيها جميع كتّاب عصر بعينه؛ وبين الأسلوب الذي هو الشكل الذي «يشكل» كلام الكاتب في بعده الشخصي والجسدي؛ ثم أخيرا الكتابة التي تتموضع بين اللغة والأسلوب، وعن طريقها يختار الكاتب ويلتزم. الكتابة هي مجال الحرية والالتزام. «اللغة والأسلوب قوى عمياء، أما الكتابة فهي فعل متفرد تاريخي. اللغة والأسلوب موضوعان، أما الكتابة فهي وظيفة. إنها العلاقة بين الإبداع والمجتمع، وهي اللغة الأدبية وقد حوَّلها التوجيه الاجتماعي، هي الشكل وقد أدرك في بعده الإنساني وفي ارتباطه بالأزمات الكبرى للتاريخ».
ما يقوله سارتر عن الأدب يقوله بارط عن الكتابة. لكن بينما يربط الأول الأدب بالالتزام السياسي للكاتب والمحتوى المذهبي لعمله، فإن الثاني ينفصل عن معلمه معلنا «أن قدرات التحرير التي تنطوي عليها الكتابة لا تتوقف على الالتزام السياسي للكاتب، الذي لا يعدو أن يكون إنسانا بين البشر، كما أنها لا تتوقف على المحتوى المذهبي لعمله، وإنما على ما يقوم به من خلخلة للغة.» هذه الخلخلة لا تعني سارتر البتة ما دام يرى أن الناثر «هو دائما وراء كلماته متجاوز لها ليقرب دوما من غايته في حديثه».
لا يمكننا أن ننكر ما كان لتدخل رولان بارط في هذا الصدد من أهمية كبرى لإنقاذ الكتابة من بقايا النظرية الإنعكاسية التي ورثها سارتر عن الماركسية، وبالتالي لإنعاش مفهوم الإلتزام ذاته. ولعل عدم التفتح على هذا النوع من الإنعاش هو الذي قد يفسر«الذبول» الذي عرفه مفهوم الإلتزام عندنا، ومن ثمت هو الكفيل بأن يعطيه من جديد نوعا من الحيوية، تلك الحيوية التي لم تفارق المفهوم في السياق الذي ترعرع فيه. إن انتعاش ممارسة الإلتزام رهينة بفتحه على هذا الأفق الجديد الذي فتحه عليه ر. بارط حينما ربطه بالكتابة من حيث هي خلخلة للغة، وليس بالكاتب وشخصه كما كان يعتقد سارتر.

 عبد السلام بنعبد العالي
عبد السلام بنعبد العالي