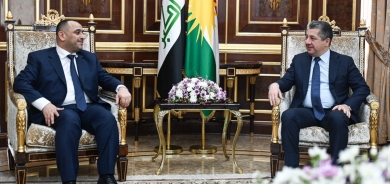تسييس الفتاوى
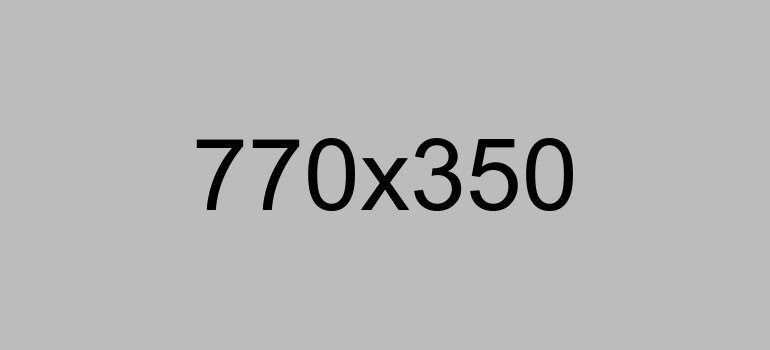
إن الإسلام دين ودنيا، وليس دينا ودولة (يعني سياسة)، فليس في تاريخ الإسلام شيء اسمه الدولة الإسلامية، بل هناك دول مسلمة نسبت إلى أهلها( دولة الخلفاء الراشدين، دولة الأمويين، دولة العباسيين، دولة الفاطميين، دولة الموحدين، دولة العثمانيين)، لأننا إذا قلنا دولة إسلامية يعني أن كل جزئية من جزئيات الدولة لا بد أن تكون مبنية على نصوص دينية، وهذا ليس صحيحا، فالإسلام فسح لنا المجال واسعا، حيث ترك لنا هذا المجال رحبا لكي نفكر ونبني دولة على اجتهاداتنا البشرية وفق مصالحنا الدنيوية، لأن الظروف تتغير والأحداث تتقلب، والوقائع تكثر وتتجدد، لأن نصوص الدين جاءت قواعد عامة تحقق السلم المجتمعي والعدالة المجتمعية، لذا لا يجوز الخروج على هذه القواعد الكلية. قال أحد علماء الإسلام القدماء، وهو ابن عقيل:" السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول(ص) ولا نزل به وحي".
هذه المقدمة ضرورية لكي نقول لأولئك العلماء الذين يفتون في القضايا السياسية، أن مجال الفتاوى ليست في عالم السياسية، بل يجب حصر هذه الفتاوى في قضايا شرعية لكي يعرف الناس حقيقة دينهم، فالسياسية ليست بحاجة إلى فتاوى بل بحاجة إلى عقل مصقول وتجربة مصقولة واجتهادات مكثفة، فالفتوى لإصلاح المجتمعات لا لإفسادها، والمؤسف أننا وجدنا في العالم الإسلامي والعربي فتاوى مخيفة لعلماء معروفين وهي تهدد السلم العالمي والمجتمعي، وتحرض على القتل والتميز العنصري والإرهاب والقتل والتكفير والتشهير، وهي فتاوى إرهابية لا بد من محاكمة أصحابها في المحاكم الدولية، لأنها بكل تأكيد تربي أجيالا على ثقافة الكراهية والحقد والبغض والضغينة، وتجعل الطرف الآخر الذي تم إطلاق هذه الفتاوى ضده عرضة للإرهاب الصارخ والتصفية الجسدية والاغتيال، وما أكثر الأمثلة على ذلك، حيث رأينا ثمار هذه الفتاوى المرة، وعلى أساس هذه الفتاوى تمت تصفية علماء كبار وقيادات ورؤوساء ومشايخ وأساتذة وطلاب ومهندسين وأطباء، فقد قتل محمود النقراشي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية سنة 1948، وقتل أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية سنة 1981، وقتل وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد حسين الذهبي سنة 1977، هذا فقط في جمهورية مصر العربية فكيف بالمناطق الأخرى، ولو استقصينا ذلك لخرجنا عن موضوعنا، هؤلاء جميعا قتلوا بناء على فتاوى أطلقها علماء التكفير والإرهاب، فأصل البلاء من هذه الفتاوى الإرهابية المحرضة على القتل والتكفير والإرهاب والكراهية، لأن هذه الفتاوى يصدرها هؤلاء للناس، فيغتر بها بعض الشباب، حيث يتم غسل أمخاخهم بصورة رهيبة، ومن ثم يحاول هذا الشاب أن يجد مكانا مناسبا وبيئة صالحة لتطبيق تلك الفتوى على أرض الواقع، لذلك نحن بحاجة إلى تجفيف منابع هذه الفتاوى من خلال استهداف أصحاب الفتاوى، فعندما نوقف أصحاب الفتاوى عند حدهم، نكون قد حفظنا شبابنا من التأثر بها، وإن كانت التكنولوجيا وسيلة فعالة يستفيد منها الشباب، ولكن لا بد من مواجهة هذه التحديات الخطيرة.
ولنضرب على ذلك مثلا ما تعرض له الكورد الإيزيديون في سنجار من جرائم يندى لها جبين الإنسانية كان تطبيقا حرفيا لتلك الفتاوى التي أطلقها الدواعش وفق أيديولجيتهم الإرهابية المغلوطة، فلولا تلك الفتاوى الإرهابية التي أطلقها علماء(جهلاء) الدواعش لما تعرض الكورد الإيزيديون في سنجار إلى تلك الجرائم والإبادة الجماعية.
دعني هنا أعطي توضيحا للقاريء حتى يعرف ماهية الفتوى، وكيف أن الفتوى في المذهب الشيعي تختلف عن الفتوى في المذهب السني، فعند الشيعة تكون الفتوى ملزمة، ولا يجوز مخالفتها قطعا، لأن المرجع الديني الأعلى هو الذي يخبر الناس عن حقيقة حكم الله في المسائل الدينية، ولا مجال للخطأ في تصورهم، والفتوى عندهم لا حدود لها، فهي تشمل جميع ميادين الحياة، ولكن الأمر يختلف في المذهب السني، فالفتوى ليست ملزمة، والمفتي يخبر عن حكم الله حسب اجتهاده، فقد يكون مصيبا، وقد يكون مخطأ.
دعني لا أذهب بعيدا، فالأولى التركيز على الفتاوى التي أطلقت ضد الكورد، نأخذ منها نماذج، فعندما حاول النظام العراقي استحصال فتوى من المرجع الديني الأعلى سماحة السيد محسن الحكيم لإباحة قتال الكورد، لم يتمكن النظام من إقناعه، بل على العكس أفتى بحرمة القتال، وهذه الفتوى كما أكدت المرجعيات ستبقى سارية المفعول، وبسبب هذه الفتوى أصبحت العلاقة طيبة ومتينة بين آل الحكيم والبارزاني الخالد، وهذه العلاقة لا تزال مستمرة، إن لم يفسدها الجيل الجديد بسبب بعض التصريحات التي نسمعها بين الفينة والأخرى، وبعض المواقف التي نراها بين الحين والآخر، وآخرها تصريحات السيد عمار الحكيم في مصر عندما ربط الدولة الكوردية بإسرائيل، وقد توترت العلاقة بين الطرفين، ولكن تمت تهدئة الأمر بعد أن زار كتلتنا ممثل السيد عمار الحكيم معتذرا وموضحا حقيقة ما جرى، ونحن بدورنا زرنا سماحته من أجل أن لا تنهار هذه العلاقة، ويستلغها الأعداء والمناوئون.
أما علماء النظام البعثي وخاصة من علماء السنة فقد كانت فتاويهم منتشرة، وما عمليات الأنفال ومعسكرات خالد بن الوليد وإستعمال أسماء الصحابة والخلفاء إلا من نتاج وثمار هذه الفتاوى الإرهابية، والمؤسف أن أحد علماء الكورد - وهو الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الذي استشهد بيد الإرهابيين في دمشق- أفتى ضد شعبه - عندما دخلت القوات الأمريكية في كوردستان لمقاتلة نظام البعث – حيث قال على المنبر يوم الجمعة بأن ( الأكراد خانوا الله ورسوله، وها أنا أضع نسبتي تحت قدمي) وهذه الفتوى تعني أن الكورد ارتدوا عن دين الله، هذه مقدمة خطيرة لأمر أخطر، ألا وهو جواز قتال الكورد، ولقد قمت آنذاك بالرد عليه في مجلة كولان العربي بالتفصيل، ثم بعد أن تم تحرير العراق، وبدأنا نؤسس لفدرلة العراق، واستطعنا أن نشكل إقليم كوردستان بصورة دستورية، جاء عالم سني آخر معروف وهو عبد الملك السعدي، ليطلق فتوى خطيرة بحرمة الفدرالية، وقد قمت بالرد عليه، مبينا، كيف تفتي بحرمة شيء لا وجود له لا في القرآن ولا في السنة، هذه مسائل دنيوية، فسح الله لنا المجال لكي نختار ما يناسب واقعنا لخدمة المواطن، لأن الهدف الأساس تحقيق العدالة، والنظام الفيدرالي يحقق العدالة، ولولا هذا النظام الديمقراطي لكان حالنا كحال بقية محافظات العراق حيث البطالة والتخلف والفساد والخراب والفوضوى والمليشيات المسلحة والنزاعات العشائرية المستمرة، ناهيك عن التدخلات الإقليمية الفاضحة والصارخة والواضحة، ثم ما لبثنا أن سمعنا بفتوى آخرى هذه المرة من مفتى أهل السنة في العراق الدكتور مهدي الصميدعي الذي أطلق فتوى ضد رفع العلم الكوردستاني في مدينة كركوك، وهذه الفتوى أضحكتني مرة، وآلمتني تارة أخرى، أضحكتني لأنه كيف يمكن لرجل درس العلوم الشرعية أن يقحم نفسه في قضايا سياسية ودستورية وقانونية، ثم يطالب الكورد بتقوى الله، هلا طالبت حكومة بغداد بتقوى الله التي قطعت قوت شعب كوردستان؟ هلا طالبت بغداد بوضع حد لتجاوزات المليشيات المسلحة التي تعيث في الأرض فسادا وجرما، هلا طالبت بغداد بمساعدة النازحين الذين يعيشون في كوردستان؟ وآلمتني هذه الفتوى، لأن الفتوى ينبغي أن في القضايا الشرعية التي يبحث الناس عن حقيقة حكم الله، وليس في قضايا سياسية يمكن للعقل البشري أن يصل إلى نتيجة مرجوة وصحيحة، ولم أقم بالرد على الدكتور الصميدعي لأن علماء الدين في كوردستان قاموا بهذا الواجب.
لا أستطيع أن استقصي جميع هؤلاء الذين أفتوا ضد الكورد وكوردستان، فهذا له مجال آخر، بل الهدف من ذكر ذلك لكي نبين للقاريء الكريم أن هذه الفتاوى جميعها بلا استثناء لا قيمة لها من الناحية الدينية والشرعية، فهي مجرد مواقف سياسية بصبغة دينية حتى يغتر بها المتدينون فقط، فلا قيمة لأي فتوى تصدر من أي عالم كائنا من كان إذا كانت في قضايا سياسية، لأن السياسة ليست بحاجة إلى فتاوى، بل بحاجة إلى عقول تفكر لكي تحقق العدالة الاجتماعية للإنسانية، فعندما نترك السياسية لأصحاب الفتاوى فسنقع في فوضى لا نهاية لها، وبسبب هذه الفتاوى اختلفنا وتقاتلنا وحارب بعضنا بعضا، ولهذا كان صحابة رسول الله(ص) أبعد الناس عن الفتاوى، وعندما كثرت الفتاوى بينهم كثر الخلاف، وتحول الخلاف إلى شقاق، ومن الشقاق إلى القتال، وأتذكر جيدا عندما احتل صدام حسين الكويت سنة 1990، تفرق علماء المسلمين سنة وشيعة إلى شقين، الشق الأول أفتى بأن ما قام به صدام حسين جهاد ضد أطماع اليهود والصليبيين، وأن هذه الخطوة مهمة لتوحيد الأمة الإسلامية، بينما الشق الثاني على العكس من ذلك تماما، هذه هي الفوضوى الحقيقية، عندما يكون مصير المجتمعات بيد الفتاوى السياسية.
إذا أردنا أن نحفظ مجتمعاتنا من هذه الفوضى الحقيقية، فلا بد أن نبعد الدين عن السياسية، لأن الدين حياة سرية نقية طيبة شفافة روحية راقية سامقة شخصانية فردانية، فهي علاقة خفية بينك وبين الله، بينما السياسية حياة علنية غير نقية ولا صافية ولا صادقة، فهي علاقة بينك وبين أفراد مجتمعك على اختلاف ألوانهم وألسنتهم، لذلك الخلط بين هذه وتلك أي بين الدين والسياسة خلط بين عالمين متناقضين جدا، لا صلة بينهما، ولا جامع ولا رابط أصلا، فمثل هذه الفتاوى التي أحدثت فوضى في مجتمعاتنا، ومزقت الوحدة الاجتماعية، وشتت اللحمة الوطنية، هي فتاوى سياسية لا تحمل أي صفة شرعية ولا صبغة دينية، ولعل أحدا يسأل بأنك تدعو في نهاية المطاف إلى العلمانية، لا شك أن مضمون أي شيء أولى من شكله، فما كتبته وقلته قناعتي، وليس يهمني ماذا سيسميه غيري مستقبلا، لأني على قناعة أن العلمانية ليست ضد الدين، بل هي تحفظ الدين من تلاعب المنافقين والسياسيين، فالدين في الدول العلمانية أكثر تأثيرا في المجتمعات من الدول التي تدعي الدين، لأن الدين في الدول العلمانية حر طليق لا أحد يتدخل في تأويله ولا في تفسيره، بينما في الدول التي تدعي الدين تجد الدين مكبلا مقيدا لا حرية له فتأثيره قليل، لأنه إما مقيد بمذهب أو تفسير أو مدرسة بشرية قد تكون على حق وقد تكون على صواب، فالدين في جميع الدول الإسلامية والعربية مقيد بمذهب، خذ مثلا في السعودية نجد الدين مقيدا بمذهب سني حنبلي، وفي إيران مقيدا بمذهب شيعي جعفري، وفي العراق نجد الدين مقيدا بمذاهب شتى، ولهذا لا نجد الراحة والاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي والعدالة الإنسانية والتعايش الديني وحقوق الإنسان في هذه البلاد بسبب أن الدين تم حبسه وسجنه وتقييده وتكبيله بسلاسل وأغلال وقيود المذاهب المختلفة التي هي ليس معصومة بل هي اجتهادات بشرية قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، بينما نجد الدين في أمريكا له تأثير بالغ في المجتمع، وذلك لأن الدستور الأمريكي لم يجعل المسيحية (البروتستانتية) Protestantism الدين الرسمي للدولة، بل إن الدين حر طليق لا قيد له، وليست المسيحية فحسب ديانة حرة، بل إن جميع الأديان حرة طليقة لا دخل للإنسان الأمريكي فيه، ومعلوم أن أمريكا دولة علمانية، والملاحظ أن الإلحاد قد أصبح ظاهرة خطيرة في دول العالم الإسلامي، بينما التدين أصبح ظاهرة سليمة في الدول التي لا تنظر إلى الدين كقضية شخصية، وليس أمرا رسميا.
وهذه العلمانية التي أتحدث عنها هي العلمانية المحدودة بالفصل بين الدين والسياسية، وهي في تصوري تقابل الدولة المدنية التي يؤمن بها كثير من علماء الإسلام، ولهذا قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس(جناح الإخوان المسلمين) أن العلمانية ليست ضد الدين، والذين يعاندون العلمانية بجميع صورها هم الإسلاميون المتطرفون، وذلك لأنهم لم يفهموا حقيقية العلمانية، ولو فهموها بصورة صحيحة علمية لما وقفوا ضدها، ولا شك أن هؤلاء خلطوا بين العلمانية الجزئية التي تقتصر على فصل الدين عن السياسية، وبين العلمانية الشاملة التي تعاند الدين وترفضه رفضا كاملا، وتعده خرافة، بل تجرد كل مقدس عن قداسته، فهي تدنس كل مقدس، ومعلوم أن العلمانية التي نحن بصددها وسيلة ناجعة لحفظ الدين من تدخلات علماء الإرهاب والتكفير والعنف والتطرف، وكذلك لصيانته من تلاعب الإسلاميين الذين يفسرون نصوص الدين وفق ما يريدون ووفق أطرهم الأيدولوجية، ولو بقي الدين حرا طليقا من الإنسان، لما وقعت هذه الحروب الدينية والمذهبية والطائفية، فما سال دم إلا بعد فتوى من شيخ متطرف، وما قتل بريء إلا بعد تحريض من مفتي ينتمي إلى هذه الجماعات التكفيرية التي أفسدت العباد والعباد.

 د. عرفات كرم ستوني * مسؤول شؤون العراق في مقر البارزاني
د. عرفات كرم ستوني * مسؤول شؤون العراق في مقر البارزاني